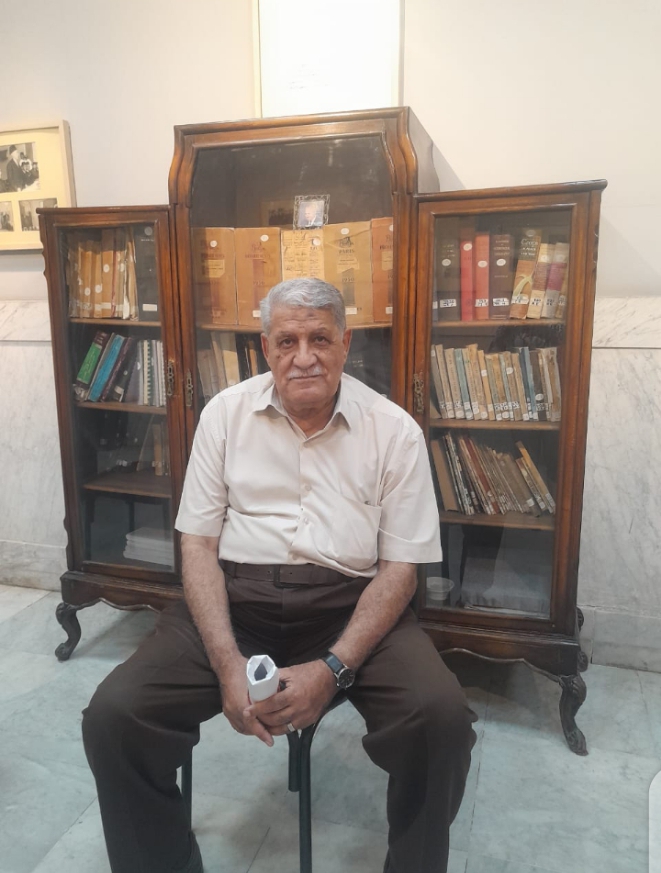أنين الحجر وصمت الحضارة»
بقلم د. فاروق شرف.
—————–
المعنى العلمي لعبارة “أنين الحجر” يُقصد به مجموعة التفاعلات الفيزيائية والكيميائية والبيئية الصامتة التي تصيب المادة الحجرية بمرور الزمن، فتؤدي إلى تدهورها البطيء دون أن يُلاحظ الإنسان ذلك مباشرة، كما لو أن الحجر “يئن” من الألم في صمت.
في زوايا المعابد والبيوت القديمة، وعلى جدران المقابر والتماثيل التي صمدت لآلاف السنين، يختبئ أنين الحجر… أنين لا يُسمع بالأذن، لكنه يُحسّ بالقلب والعقل.
فالحجر الأثري ليس جمادًا صامتًا كما يظن البعض، بل هو كائن مادي حيّ بمعناه العلمي، يتنفس من مسامه، ويتأثر بحرارة الشمس وبرودة الليل، ويفرح حين يُرمم، ويتألم حين يُهمَل أو يُساء إليه.
لقد حفظ الحجر ذاكرة الحضارة، فكان شاهدًا على مجد الإنسان وعبقريته، لكنه اليوم يشهد أيضًا على صمته تجاه ما يعانيه الأثر من عبث وسوء معاملة.
إن أنين الحجر هو صرخة خفية ضد ضجيج الحاضر، وضد الإهمال الذي يُطفئ بريق التاريخ، ليذكرنا بأن الحضارة لا تُقاس بما نبنيه فقط، بل بما نصونه مما تركه الأجداد.
ومن هنا تأتي أهمية الوعي الأثري والعلمي في فهم العلاقة الدقيقة بين المادة الأثرية والبيئة المحيطة، وبين الإنسان الذي صنعها والإنسان الذي يرعاها، حتى لا يتحول صمت الحضارة إلى نداء ضائع في زحمة الأصوات العابثة.
هل يتأثر الحجر كما يتأثر الإنسان؟
——————————————–
نعم، فالحجر — رغم جموده الظاهري — كائن مادي حيّ بمعناه العلمي، يتفاعل مع بيئته المحيطة تأثرًا وتأثيرًا.
* يتنفس: إذ يتم تبادل الغازات والرطوبة عبر مساميته الدقيقة، مما يتيح له “التنفس” الطبيعي في ظروف مناخية متزنة.
* يتغذى: من خلال عمليات التشريب أو السَّقْسَقة أو الغمر بمحاليل التقوية التي تعمل على تغذية بنيته المسامية وإعادة ترابط حبيباته المعدنية.
* يفرح: عندما يُجرى له التنظيف الميكانيكي أو الكيميائي ، فيستعيد بريق سطحه ورونق نسيجه الأصلي بالإضافة كونه بمكان فيه الهواء نقى و بعيدء عن عوادم السيارات.
* يتألم: حين يتعرض للضغوط الميكانيكية، أو لدرجات الحرارة العالية والحرائق، أو لتقلبات الرطوبة النسبية، أو لمياه الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، أو للهزات الأرضية التي تُحدث تصدعات داخلية مدمرة لبنيته البلورية.
وهل يتأثر الحجر ببني الإنسان؟
—————————————-
نعم، فالسلوك البشري الخاطئ يُعد من أخطر المؤثرات السلبية على الأثر، ويتمثل في:
. الضغط المباشر أو الدوس على سطحه.
. تسرب مياه الصرف الصحي إلى طبقاته السفلى.
. أعمال الترميم الخاطئة التي تفقده أصالته المادية والجمالية.
. اللمس والكتابة على سطحه وتشويه ملامحه.
. التعرض للأصوات العالية والإضاءة المفرطة والأشعة الضارة.
وأخيرًا، إهانة قدسيته بإقامة الحفلات الصاخبة في جواره، مستخدمين الألعاب النارية وأشعة الليزر، فيُصاب الأثر بما يشبه الألم الإنساني نتيجة هذا العبث البصري والصوتي.
مظاهر المضايقات على الأحجار الأثرية :
————————————–
أولًا – الحرارة الموسمية:
تُعد التغيرات الحرارية من أهم العوامل الفيزيائية المؤثرة على الأحجار الأثرية. إذ تتعرض الأسطح الحجرية لأشعة الشمس لفترات طويلة، فترتفع درجة حرارة السطح وتنتقل السخونة تدريجيًا إلى الداخل. وعند غياب الشمس يبرد السطح الخارجي سريعًا بينما تبقى الحرارة في الطبقات الداخلية، فينشأ فرق حراري بين السطح والباطن. ومع تكرار هذه العملية يوميًا عبر الزمن، تتعرض الطبقات الخارجية لإجهادات حرارية متتابعة تؤدي إلى حدوث شروخ دقيقة ثم تتسع تدريجيًا مسببة تشقق السطح وضعف تماسكه البنيوي.
ثانيًا – الرطوبة النسبية:
تتسلل الرطوبة إلى الحجر إما من خلال تلاصقه المباشر مع الأرض الرطبة أو عبر المسام الشعرية الدقيقة في السطح، سواء كانت محمّلة بالأملاح أو خالية منها. وفي كلتا الحالتين تعمل على إذابة الأملاح الموجودة داخل النسيج الحجري، فتتحرك هذه المحاليل بين المسافات البينية حتى تصل إلى السطح، حيث تتبخر المياه نتيجة تأثير الحرارة أو حركة الهواء، وتبقى الأملاح لتتبلور داخل المسام أو فوق السطح. ومع تكرار عملية الذوبان والتبلور تتكون بلورات الملح التي تُحدث ضغطًا داخليًا يؤدي إلى تفكك الحبيبات وتقشر السطح وفقدان طبقات الزخرفة.
ثالثًا – الرياح:
تؤثر الرياح على الأسطح الحجرية بوسائل متعددة؛ فهي تحمل حبيبات الرمال التي تعمل كأداة صنفرة طبيعية، خاصة في المواقع الأثرية الصحراوية، مما يُحدث تآكلًا تدريجيًا في الطبقة الخارجية. كما قد تنقل الرياح جزيئات ملوثة أو أيروسولات تحتوي على أكاسيد ومعادن ثقيلة تلتصق بسطح الحجر، فتكوّن طبقات من البقع السوداء والملوِّثات، وتُسهم في تسريع عمليات التملّح وتغير اللون.
رابعًا – الأمطار:
غالبًا ما تكون مياه الأمطار محمّلة بأكاسيد ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الملوثات الجوية، فتذوب هذه الأكاسيد في قطرات المطر مكوّنة أحماضًا ضعيفة مثل حمض الكبريتيك وحمض الكربونيك. ورغم ضعف تأثيرها الكيميائي اللحظي، إلا أن استمرار استقرارها على الأسطح الحجرية يؤدي إلى تفاعلها مع المكوّن الأساسي للحجر، وهو كربونات الكالسيوم، فتتكون مركبات هشة مثل كبريتات الكالسيوم أو بيكربونات الكالسيوم، وهي طبقات رخوة قابلة للتقشر والانفصال حتى بفعل الرياح الهادئة.
خامسًا – العوامل الكيميائية:
تتضمن هذه العوامل التفاعلات التي تحدث بين مكونات الحجر والمواد الكيميائية المحيطة به في البيئة، سواء كانت ناتجة عن التلوث الصناعي أو المواد المستخدمة في الترميم الخاطئ. فالأحماض، والأملاح، والأكاسيد الغازية يمكن أن تتفاعل مع المعادن المكوّنة للحجر محدثة تغيّرات في لونه وبنيته وتماسكه. كما أن استخدام مواد غير متوافقة كيميائيًا في عمليات الترميم، مثل بعض الراتنجات أو مواد اللصق الصناعية، يؤدي إلى تكوين طبقات غير متجانسة تُعيق “تنفس” الحجر وتتسبب في انفصالها بمرور الوقت.
سادسًا – العوامل البيولوچية:
تشمل نمو الكائنات الحية الدقيقة على الأسطح الحجرية مثل الطحالب، والفطريات، والبكتيريا، إضافة إلى النباتات الصغيرة التي تتجذر في الشقوق. هذه الكائنات تُفرز مواد عضوية وأحماضًا تؤثر على مكونات الحجر وتعمل على تآكل سطحه وتغيير لونه الطبيعي. كما تساهم الجذور النباتية في توسيع الشروخ، بينما تُحدث الفطريات غشاءً لزجًا يحتجز الرطوبة، مما يرفع نسبة التدهور البيولوجي.
سابعًا – العوامل البشرية:
تُعد من أخطر المظاهر المؤثرة على الأحجار الأثرية، إذ يتسبب الإنسان بسلوكياته غير الواعية في إحداث أضرار جسيمة، منها الضغط المباشر أو الجلوس على الأسطح الحجرية، وتسرب مياه الصرف الصحي في محيط الأثر، وأعمال الترميم غير العلمية التي تُفقد الحجر أصالته التاريخية. كما تتسبب الملامسة المباشرة، والكتابة، والرسم على الأسطح في تشويه المظهر الجمالي. ويُضاف إلى ذلك الأثر السلبي للصوت العالي، والإضاءة الشديدة، والأشعة الضارة، وما يُقام من احتفالات صاخبة بالقرب من المواقع الأثرية باستخدام الألعاب النارية والليزر، وكلها عوامل تُحدث اهتزازات وتذبذبات ميكروسكوبية تُضعف التماسك البنيوي للحجر وتفقده استقراره الزمني.
ما هو الصوت المؤثر على الآثار الحجرية؟
—————————————————–
* الصوت المؤثر على الأحجار الأثرية هو ذلك الذي تتجاوز شدته الحد الطبيعي للبيئة الأثرية، أي ما يزيد عن 70 – 80 ديسيبل في نطاق الترددات المنخفضة (من 10 إلى 200 هرتز تقريبًا).
هذا النطاق يُحدث:-
. ذبذبات متكررة في الطبقات الخارجية للأحجار، مما يسبب انفصالها التدريجي.
. تخلخلًا في المسامية الدقيقة يؤدي إلى تسرب الرطوبة والملوثات.
.إجهادًا بنيويًا داخليًا يشبه تمامًا تأثير الهزات الأرضية الدقيقة المتكررة.
وقد أثبتت دراسات هندسية وأثرية (منها أبحاث المركز القومي للبحوث بمصر، ودراسات اليونسكو حول “الاهتزازات البيئية في المواقع الأثرية”) أن تكرار التعرض للأصوات الشديدة خاصة تلك الناتجة عن الحفلات الموسيقية أو الألعاب النارية بالقرب من الآثار، يؤدي إلى تدهور تدريجي غير مرئي في المدى القصير، لكنه مدمّر على المدى البعيد.
ختامًا :
———
فإن ما يتعرض له الحجر الأثري من عوامل طبيعية وكيميائية وبيولوجية وبشرية لا يمثل مجرد تهديد مادي لسطحه وصلابته، بل هو خطر حقيقي على ذاكرة الأمة وملامح حضارتها. فالتآكل الناتج عن الأمطار الحمضية، والتصدعات التي تولدها الذبذبات الصوتية، والنمو الميكروبي غير المرئي، والإهمال الإنساني أو سوء الاستخدام — جميعها تشترك في تفكيك منظومة التوازن التي حافظت على الأثر قرونًا طويلة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تطبيق المعايير الدولية للحماية والترميم، التي تؤكد على مبدأ “الوقاية خير من الترميم”، وعلى أن الحفاظ على المادة الأصلية للأثر هو حفاظ على صدقه التاريخي وهويته الثقافية. إن الترميم لا يعني فقط إصلاح حجر، بل إحياء روح حضارة، وصون شهادة خالدة أودعها الإنسان القديم في صخر الزمن.